“ترامب الثّاني” في خليج جديد
نايف سالم – الكويت
«أساس ميديا»
بين أيّار 2017 وأيّار 2025، اختلَفَت دول الخليج جذريّاً بسياساتها واستراتيجياتها. في التاريخ الأوّل زارها “ترامب الأوّل” لتثبيت الشراكات ونسج الصفقات الدفاعية والتجارية الكلاسيكية، فيما يزورها في التاريخ الثاني بأولويّات مختلفة، ربطاً بالتغيّرات العميقة في السياسات والتوجّهات لكلا الجانبين.
من “الاقتحام الخليجي” للذكاء الاصطناعي ضمن إرساء منظومة الحداثة، مروراً بسياسة “إطفاء الحرائق” عبر “تصفير المشكلات” تقريباً مع إيران وغير إيران والوساطات الكبرى (أوكرانيا والسودان مثلاً)، وصولاً إلى رسوخ الاتّفاقات الإبراهيمية بين بعض الدول الخليجية وإسرائيل، وثبات الموقف السعودي من قيام الدولة الفلسطينية شرطاً للتطبيع، يمكن استخلاص 3 اختلافات كبرى بين 2017 و2025.
تتركّز كلّ أنظار العالم هذه الأيّام على دول الخليج التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتكون محطّته الخارجيّة الأولى في ولايته الثانية (2024 – 2028) كما كانت أيضاً في ولايته الأولى (2016 – 2020).
لكنّ الفارق كبيرٌ بين المحطّتَين، إذ يحطّ “ترامب الثاني” رحاله في أرضٍ وعلى أرضيّة مختلفة. المملكة العربية السعودية، بثقلها العالمي، تحتضن خامس قمّة أميركية- خليجية، بعد الأولى (أيّار 2015) والثانية (نيسان 2016) والثالثة (أيّار 2017) والرابعة (تمّوز 2022).
سترسم هذه القمّة مسار الشراكة الاستراتيجية بين الخليج وأميركا لسنوات طويلة، ومن شأنها تثبيت علاقة الشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. لا يريد ترامب الحروب، وكذلك دول الخليج. يريد ترامب تدفّق المزيد من الأموال الخليجية إلى الولايات المتّحدة (تحت شعار أميركا أوّلاً)، ولا تُمانع دول الخليج ضخّ استثمارات جديدة في الشرايين الأميركية، مقابل الاستفادة من قدرات الشركات الكبرى، لا سيما ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات واستكشاف الفضاء.
يرغب ترامب بتهدئة الوضع في المنطقة وإبعاد شبح الحروب، ودول الخليج تدفع بقوّة باتّجاه إنهاء حرب غزّة وتعوّل على قدرة أميركا على تهدئة “الثور الإسرائيلي الهائج”. تؤيّد أيضاً اتّفاقاً شفّافاً مع إيران يمنعها من حيازة السلاح النووي، وترتكز على علاقاتها “الإيجابيّة بحذر” مع طهران، مقارنة بما كانت عليه في 2017، لمعالجة الملفّات الأخرى (الأنشطة الخبيثة).
السّلاح والذّكاء
وفق ذلك، يندرج إعلان وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عشيّة وصول ترامب، تأسيس شركة “هيوماين” التي تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي وإدارة حلوله وتقنيّاته، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين ثلاث قارّات.
ربّما “هيوماين” كانت محور الحوار “الجانبيّ” بين محمّد بن سلمان وترامب وإيلون ماسك، الذي يرافق الرئيس الأميركي مع عدد من كبار الرؤساء التنفيذيّين في الشركات الأميركية الكبرى، مثل “أمازون” و”بلاك روك” و”آي بي إم” و”بوينغ” و”دلتا إيرلاينز” و”أميركان إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” و”أوبر” و”كوكاكولا” و”غوغل”.
كان الذكاء الاصطناعي أيضاً محور “زيارة العمل” التي قام بها مستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد لواشنطن، في آذار الماضي، والتقى خلالها ترامب وكبار المسؤولين ورؤساء شركات عالمية، مع التركيز على آفاق الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدّمة.
ستبقى صفقات السلاح الأميركية لدول الخليج قائمة وتتعزّز، لكنّ “الذكاء الاصطناعي” سيتقدّم عليها. لم يعد يهمّ دول الخليج ترسانات الأسلحة بقدر ما يهمّها الاستثمار في المستقبل واحتضان “بنوك البيانات” والبنية التحتيّة للذكاء الاصطناعي، تطبيقاً لرؤاها الاقتصادية والتنموية الطموحة (السعودية 2030، الكويت 2035، قطر 2030، البحرين 2030، عُمان 2040، الإمارات 2040).
إطفاء النّيران
المشهد في السياسة أيضاً مُختلف جذريّاً. لم تعد إيران الخطر الأساس والتهديد الأوّل في 2025. التفاهمات الثنائية بينها وبين بعض دول الخليج فعلت فِعلها. انكسار “المحور” أجبَرَ الرؤوس الحامية في طهران على الانكفاء.
بات ترامب يفاوضها ويريد “صفقة التريليونات” التي فرشتها له علناً بأيدي وزير خارجيتها عباس عراقتشي ومستشار مرشدها علي لاريجاني.
مع اتّخاذ العلاقات مع إيران منحى التهدئة والاستيعاب، تلتقي السياسة السعودية والخليجية مع الأميركية في الرغبة بإطفاء النيران المشتعلة في أكثر من مكان، مثل اليمن والسودان. وبات الوسيط الخليجي لا غنى عنه في الملفّات الكبرى، وبدا ذلك واضحاً في صفقات تبادل الأسرى المتلاحقة التي رعتها السعودية والإمارات، وفي الوساطة السعودية بين أميركا وروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا، و”منبر جدّة” الذي لا بديل عنه لإنهاء حرب السودان مهما طالت.
تريد دول الخليج “وأد” الحروب من أجل إطلاق “عملاق التنمية”، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاداتها وازدهاراً على جيرانها من دول المنطقة. وتولي أهميّة خاصّة لدعم سوريا ولبنان “الجديدَيْن”، وإن لا يزالا تحت الاختبار، وتلعب دوراً إيجابياً كبيراً في دفع الولايات المتّحدة لمنحهما فرصة لالتقاط الأنفاس وإقران الأقوال بالأفعال، من خلال رفع أو تخفيف العقوبات والإجراءات المشدّدة، التي فُرضت عليهما إبّان حُكمَي بشّار الأسد و”الحزب”.
الثّور الإسرائيليّ
في العلاقات مع إسرائيل الوضع مختلف أيضاً. أكبر إنجازات ترامب في ولايته الأولى كان “الاتّفاقات الإبراهيمية” التي أدّت إلى تطبيع العلاقات بين الدولة العبريّة وبعض الدول العربية، بينها دولتان خليجيّتان: الإمارات والبحرين.
على الرغم من “البهلوانيّات” الأميركية المتنوّعة، إبّان إدارة جو بايدن، لم تنجح واشنطن في “حرف” الرؤية السعودية الثابتة عن مسارها: لا تطبيع قبل قيام دولة فلسطينية. والآن فهمت إدارة ترامب مدى صلابة هذه الرؤية فأقرّت بالمعادلة الجديدة: مساعدة المملكة في طموحاتها النووية شيء والتطبيع شيء آخر.
هنا لا تبتعد أيضاً الرؤية الخليجية عن الرؤية الأميركية. كلتاهما، لأسباب مختلفة، تريد وقف حرب الإبادة في غزّة. لكنّ الطرف الأميركي هو القادر حصراً على تهدئة “الثور الهائج” المتمثّل بحكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرّفاً في تاريخ الكيان، وإفهامه أنّ السلام يقوم على أسس واضحة، عنوانها “الدولة الفلسطينية” التي تتشبّث السعودية بدعمها والدفع نحو إقامتها، مهما بلغت أعداد “السموتريتشيّين” و“البن غفيريّين” في حكومات الدولة العبريّة.
نايف سالم – الكويت

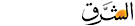
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.