لبنان: استمرار الخيارات البائسة
بقلم نديم قطيش
«أساس ميديا»
وقف، عام 1973، كلّ من لبنان ودولة الإمارات العربية المتّحدة التي كانت قد تشكّلت حديثاً، عند نقطة انطلاق متشابهة. بلغ الناتج المحلّي الإجماليّ للبنان 3.5 مليارات دولار، متقدّماً بضآلة على 2.6 مليار دولار للإمارات. كان كلاهما على أهبة الاستعداد لالتقاط “الغنائم” التي وعد بها تضاعف أسعار النفط أربع مرّات ذاك العام.
كان لبنان، مفخرة الشرق الأوسط حينها، جاهزاً بمصارفه المتطوّرة، وسياحته المزدهرة، وقوّته العاملة المتعدّدة اللغات، لركوب موجة البترودولار الخليجيّ، وما فتحه من آفاق استثماريّة وتنمويّة. أمّا الإمارات، فكانت مجرّد اتّحاد ناشئ بالكاد يبلغ عمره عامين. انبثق، بفعل إرادة الشيخين الراحلَين زايد بن سلطان آل نهيّان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، من رحم منافسات قبليّة شرسة على الحدود والموارد، وفي لحظة ارتباك الكولونياليّة البريطانيّة في خريفها.
بعد خمسة عقود، أصبح التباين بين البلدين مروّعاً. يقف اقتصاد الإمارات اليوم عند 537 مليار دولار، متجاوزاً نصيب الفرد من الدخل حاجز الـ50,000 دولار. أمّا لبنان، الذي مزّقته أزمة تلو أخرى، فقد انكمش اقتصاده ليصبح ما بين 18-20 مليار دولار تقريباً، مع نصيب فرد لا يتجاوز 5,280 دولاراً.
لا يكفي النفط لاختصار هذه الحكاية. فلو أخذنا سنغافورة بعين الاعتبار، التي انطلقت من اقتصاد بحجم مليار دولار عام 1965، وبلا أيّ موارد طبيعيّة، سنجدها تتباهى اليوم باقتصاد 547 مليار دولار ودخل فرد يتجاوز 80,000 دولار.
ما نحن بإزائه هو حكاية اختيارات مدمّرة، لا تزال بنيتها الأساسيّة تهيمن على واقع السياسة اللبنانيّة.
خيارات الإمارات تركّزت على عدم السماح للصدوع القبليّة بالنموّ، كما حدث بشكل مأساوي في اليمن أو الصومال. قاد الشيخ زايد موارد أبوظبي بوصفها موارد الاتّحاد كلّه، وصمّم رؤية توظيف عائدات النفط بشكل استراتيجيّ ومُحكم، عبر صناديق سياديّة ضخمة، وبنية تحتيّة عملاقة، وخطوط طيران، ومناطق تجاريّة حرّة.
اليوم، تساهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 75% من الناتج المحلّي الإجماليّ. تبنّت البلاد سياسات محكمة لتنويع الاقتصاد، واعتمدت معايير الجدارة (Meritocracy) في التخطيط والتوظيف وجذب الكفاءات، وسيَّجت الأمن والاستقرار بالدبلوماسيّة الواقعيّة الباردة، التي أفضت إلى الاتّفاقيّات الإبراهيميّة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. أثبتت الإمارات، على غرار تحوّل سنغافورة المدفوع بالتصنيع وإجراءات مكافحة الفساد الصارمة، أنّ الحوكمة المنضبطة تنوب عن بل تتجاوز مفاعيل الثروات الطبيعيّة.
سلسلة قرارات خاطئة
بالتوازي مع هذه التجربة، كان كلّ ما يحصل في لبنان يعمل على تبديد مزايا البلاد عبر سلسلة متتالية من القرارات الخاطئة والمصيريّة. يُبرز، في أوائل السبعينات، ارتفاع التحويلات الماليّة من 250 مليون دولار إلى 910 ملايين دولار بحلول عام 1975، المسار الذي كان مهيّأً للبنان، لأن يكون المركز الماليّ الإقليميّ الأبرز.
بدلاً من ذلك، سُمح للمسألة الفلسطينيّة، والتنازل الطوعيّ عن السيادة لصالح سلاح منظّمة التحرير، أن يفجّرا التوتّرات الطائفيّة ويُغرقا البلاد في حرب أهليّة استمرّت حتّى عام 1990. لقد دمّر الصراع البنية التحتيّة والمجتمعيّة، حتّى صار مصطلح “اللبننة” مرادفاً للمرض والتشظّي وكلّ ما ينبغي على الدول والمجتمعات اجتنابه.
لا تقلّل هذه السرديّة من أثر الاحتلال العسكريّ السوريّ (1976-2005) الذي فاقم الأزمات وعمّقها، متلاعباً بالتناقضات الطائفيّة وصولاً إلى تمكين ميليشيا “الحزب”، بالتحالف مع إيران. بيد أنّ لبنان لم يكن عاجزاً تماماً.
حين عبّر اللبنانيّون عن إرادتهم بشكل جامع في ثورة الأرز 2005، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، استطاعوا إخراج سوريا من لبنان، خلافاً لكلّ التصوّرات الدوليّة التي كانت سائدة في حينه.
قبل ذلك كان اتّفاق الطائف، الذي يعدّ آخر تسوية عربيّة كبرى في ظلّ الحرب الباردة، وأوّل تسوية تمهّد لمرحلة الهيمنة الأميركية على الشرق الأوسط. جاء الاتّفاق في لحظة انتقاليّة دقيقة بين زمنين، كان يترنّح فيها الاتّحاد السوفيتيّ تحت ثقل أزماته الداخليّة، فيما كانت الحرب الباردة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتتهيّأ الولايات المتّحدة لتنفرد بقيادة النظام الدوليّ.
أمّا على المستوى الإقليميّ، فالعالم العربيّ كان يحاول لملمة شتاته بعد حرب العراق وإيران، وسط تصدّعات داخليّة وصعود نفوذ الأنظمة الإقليمية الكبرى كالسعوديّة وسوريا. بعد أقلّ من عام على توقيع الاتّفاق، جاء غزو صدّام حسين للكويت في آب 1990 ليكرّس التحوّل الكامل في موازين القوى، حيث انتقلت المنطقة إلى مرحلة جديدة من الوصاية الأميركيّة المباشرة.
فرصة الطّائف
وفّر اتّفاق الطائف فرصة للّبنانيّين لأخذ مصيرهم بجدّية أكبر. غير أنّ المزاج اللبنانيّ العامّ، المجبول بثقافة التسويات المؤقّتة وتجنّب المواجهة مع المشكلات البنيويّة، حوّل هذه الفرصة إلى هدنة أكثر منها مصالحة حقيقيّة.
بدل أن يكون الطائف لحظة تأسيس لنظام سياسيّ متين، صار إطاراً لتقاسم النفوذ بين الطوائف والزعامات. مع كلّ أزمة، كان اللبنانيون يعودون إلى منطق “تدوير الزوايا” بدل الحسم، ما جعل النظام هشّاً وعاجزاً عن إنتاج دولة قادرة. في كلّ مرّة كانت التسويات الوهميّة تنهار، كان ميزان القوى الداخليّ والإقليميّ يميل ضدّ التجربة اللبنانية الوطنيّة، لتتحوّل فترات السلم القصيرة إلى فواصل بين جولات صراع جديدة.
شكّل عام 2000 لحظة مفصليّة أخرى في تاريخ لبنان مع الانسحاب الإسرائيليّ من الجنوب بعد احتلالٍ دام أكثر من عقدين. كان يُفترض أن يكون التحرير مناسبة لاستعادة الدولة سيادتها الكاملة وتوحيد اللبنانيّين حول مشروع وطنيّ جامع، لكنّ الفرصة ضاعت مجدّداً. بدل أن يتحوّل الحدث إلى انتصار للدولة، جرى احتكاره كـ”نصر” فئويّ عزّز منطق “المقاومة” على حساب الشرعيّة.
في حين مالت القوى الإسلاميّة إلى مهادنة هذا الواقع وتجنّب الصدام مع السلاح، عُزل الموقف المسيحيّ الذي دعا إلى استكمال بسط سلطة الدولة، ما عمّق الانقسام الأهليّ وأعاد إنتاج الثنائيّة بين منطق الدولة ومنطق الدويلة. هكذا تحوّل التحرير من فرصة لاكتمال “الطائف” إلى محطّة جديدة لتعميق الشرخ الوطنيّ.
محزن حجم التفاوت بين تجربة لبنان وفرصه الضائعة وبين التحوّلات الناجحة والملهمة في دول شهدت صراعات وانقسامات وفصولاً جحيميّةً من العنف. صاغت جنوب إفريقيا بعد الفصل العنصريّ مصالحة عبر انقسامات أعمق من التي عاشها لبنان. أنهى اتّفاق الجمعة العظيمة في أيرلندا عقوداً من العنف من خلال بناء مؤسّسات شاملة وفعّالة. أمّا سنغافورة والإمارات فقد اختارتا البراغماتيّة على الأيديولوجية، والوحدة على التشرذم، والسلام على الصراع الدائم. كانت لدى لبنان فرص مماثلة، بعد الحرب الأهليّة، وبعد الانسحاب الإسرائيليّ، وبعد الانسحاب السوريّ، وخلال الربيع العربيّ، لكنّه اختار خلاف ذلك مراراً وتكراراً.
نماذج بتحدّيات أقسى
لا يختلف اثنان على التعقيدات الاستثنائيّة التي تواجه لبنان، بدءاً من موقعه الجغرافيّ في قلب الصراعات الإقليميّة، والاحتلالات المتعاقبة، والتدخّلات الخارجيّة من سوريا وإيران وإسرائيل، وصولاً الى تركيبة طائفيّة معقّدة. لكنّ التاريخ المعاصر يقدّم أمثلة لدول واجهت تحدّيات أكثر قسوة ونجحت في تجاوزها.
عاشت كوريا الجنوبيّة احتلالاً يابانيّاً وحشيّاً استمرّ عقوداً، ثمّ حرباً أهليّة مدمّرة في الخمسينات قتلت الملايين وقسمت البلاد قسمة قسريّة، مع جارة عدائيّة في الشمال مدعومة من قوّتين عظميَين (الصين والاتّحاد السوفيتيّ)، وقواعد عسكريّة أميركيّة دائمة على أراضيها. كانت كوريا الجنوبية في الخمسينات أفقر من لبنان، لكنّها بنت اليوم اقتصاداً بحجم 1.7 تريليون دولار ونصيب فرد يتجاوز 33,000 دولار.
أمّا رواندا، فبعد إبادة جماعيّة راح ضحيّتها 800 ألف إنسان في مئة يوم فقط، وبعد انهيار كامل للدولة والمجتمع، استطاعت خلال جيل واحد أن تبني مؤسّسات فاعلة وتحقّق استقراراً ونموّاً اقتصاديّاً ملحوظاً، وأن تصبح نموذجاً إفريقيّاً في الحوكمة ومكافحة الفساد.
المصير اللبنانيّ البائس، ليس حتميّة تاريخيّة أو جغرافيّة، بل هو نتاج فشل ذريع في توظيف الإرادة الحرّة للّبنانيّين، بل وخيانتها في أحيان كثيرة، وتحالف المتخاصمين السياسيّين عليها، لحماية نظامٍ يعيد إنتاج العجز ويكافئ الرداءة.
بالتأكيد منحت الموارد الطبيعيّة مزايا للبعض من دون الآخرين، لكنّ الرخاء يتدفّق في نهاية المطاف من الحوكمة، والاستقرار، والرؤية الاستراتيجيّة. تعدّ فنزويلا مثالاً صارخاً على ذلك. هي صاحبة أكبر الاحتياطات النفطيّة المؤكّدة عالميّاً، ومع ذلك انهار اقتصادها وتفكّكت مؤسّساتها، في غياب الحوكمة الرشيدة، وارتهان القرار الاقتصاديّ للسياسة الشعبويّة، وتآكل مؤسّسات الدولة تحت ثقل الفساد والمحسوبيّة.
بنَت الإمارات وسنغافورة نجاحاً دائماً من خلال خيارات منضبطة. أمّا لبنان، وعلى الرغم من موقعه الأفضل في بداية السباق، فقد اختار الانقسام والصراع والتهرّب الدائم من حلّ مشاكله، وهو ما يحصل اليوم مجدّداً في التعامل مع سلاح “الحزب” الذي يُفترض أنّه خرج تماماً من سرديّة المقاومة.
الدرس واضح: قد تحدّد الجغرافيا مسرح التجارب للدول والشعوب، لكنّ الخيارات هي التي تكتب السيناريو. مأساة لبنان هي أنّ السيناريوهات الأفضل لا تزال متاحة، إذا اختار قادته أن يتبنّوها.
نديم قطيش

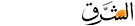
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.