أزمة سد النهضة وسبل معالجتها
بقلم د. ابراهيم العرب
تُعد أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير، واحدة من أبرز القضايا الجيوسياسية في منطقة حوض النيل، حيث تمثل نقطة توتر محورية بين دول المصب، مصر والسودان، ودولة المنبع، إثيوبيا. بدأ بناء السد على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد 6.45 جيجاواط من الكهرباء، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم.
ترى إثيوبيا في المشروع رمزًا لنهضتها، وأداة حيوية لتحقيق التنمية وتوفير الكهرباء لملايين المواطنين، مع إمكانية تصدير الفائض للدول المجاورة. لكن هذا المشروع يثير قلقًا عميقًا لدى كلٍّ من مصر والسودان. فمصر تعتمد على مياه النيل بنسبة تتجاوز 97% من احتياجاتها المائية، وأي تقليص في حصتها يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، والغذائي، والاجتماعي. أما السودان، فرغم ما قد يجنيه من فوائد مثل تنظيم تدفق المياه وتقليل الفيضانات، إلا أنه يعرب عن مخاوف جدّية من سلامة السد وتأثيراته على سدوده وأراضيه الزراعية، نظرًا لقربه الجغرافي الشديد من موقع السد.
وقد تجددت الأزمة مؤخرًا مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن اكتمال بناء السد واستعداده لافتتاحه رسميًا في سبتمبر المقبل، واصفًا السد بأنه «رمز للبركة والمنفعة المتبادلة، وليس مصدرًا للصراع أو التهديد». غير أن هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة تعقيدات المفاوضات المتعثرة، وأثار المخاوف من أن تؤدي التصرفات الأحادية الإثيوبية إلى زعزعة الأمن الإقليمي.
وبالتالي، ترتكز الأزمة على التباين بين الرؤى والمصالح: فإثيوبيا ترى أن استغلال مواردها المائية هو حق سيادي غير قابل للتفاوض، وتعتبر الاتفاقيات القديمة، كاتفاقية 1902 واتفاقية 1929، اتفاقيات استعمارية لا تعترف بها. في المقابل، تتمسك مصر والسودان بحقوقهما التاريخية في مياه النيل، وتعتبران تلك الاتفاقيات أساسًا قانونيًا لا يمكن تجاوزه.
في هذا السياق، برز مجددًا الدور الأميركي، فقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعمل على تسوية النزاع، ما أعاد الأمل بإمكانية تحريك الجمود الدبلوماسي. وقد رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذه التصريحات، مشيدًا بحرص ترامب على تحقيق اتفاق عادل ومتوازن. ولكن سبق لواشنطن أن رعت جولة من المفاوضات بمشاركة البنك الدولي في عهد ترامب، أسفرت عن مشروع اتفاق فني وقانوني، غير أن إثيوبيا رفضت توقيعه. ومع ذلك، فإن إعلان أديس أبابا اليوم عن اكتمال بناء السد، قد يُظهر مرونة أكبر، خصوصًا مع توفر الفيضانات في السنوات الأخيرة، وضغط واشنطن بوصفها ممولًا ومؤثرًا إقليميًا. كما أن سعي ترامب لتسجيل إنجاز دولي قد يدفعه لممارسة ضغوط فعلية على إثيوبيا.
أما من وجهة النظر القانونية، فيُعد سد النهضة مخالفًا للقانون الدولي، حيث انتهكت إثيوبيا «إعلان المبادئ» الموقع عام 2015، الذي ينص على التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. كما أخفقت في تبادل البيانات مع مصر والسودان، ولم تراعِ مبدأ «عدم التسبب في ضرر ذي شأن». وهنالك تشابه في هذه الحالة مع قضية «غابشيكوفو – ناغيماروس» أمام محكمة العدل الدولية، حين أقدمت تشيكوسلوفاكيا (سلوفاكيا لاحقًا) على تنفيذ مشروع مائي أحادي الجانب أضر بالمجر، ما عزّز موقف الأخيرة. وبالقياس على ذلك، فإن تعبئة سد النهضة من طرف واحد تضع إثيوبيا في موضع قانوني مشابه.
ولمعالجة هذه الأزمة، يمكن اقتراح جملة من المسارات:
1. العودة إلى مفاوضات جادة وملزمة: ينبغي استئناف الحوار بين الدول الثلاث بروح من حسن النية، للتوصل إلى اتفاق قانوني شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة في فترات الجفاف.
2. تفعيل الوساطة الدولية: يمكن للولايات المتحدة أو أي طرف دولي موثوق أن يلعب دورًا حاسمًا في تقريب وجهات النظر، على أن تكون الوساطة مدعومة بآليات تنفيذ تضمن الالتزام.
3. الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997: يُقترح أن تنضم الدول الثلاث إلى هذه الاتفاقية الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية، لما فيها من مبادئ تحمي حقوق الدول المتشاطئة.
4. اللجوء إلى محكمة العدل الدولية: يمكن لمصر والسودان طلب رأي قانوني أو رفع دعوى، لإثبات انتهاك إثيوبيا للقانون الدولي، رغم أن هذا المسار يتطلب موافقة الأطراف المعنية أو الأمم المتحدة.
5. اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي: بصفته مسؤولًا عن حفظ السلم والأمن الدوليين، يمكنه النظر في القضية إذا ثبت وجود تهديد محتمل للاستقرار الإقليمي.
6. بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي: على المدى البعيد، يجب التوجه نحو شراكة استراتيجية بين دول حوض النيل عبر تبادل البيانات، وإنشاء مشاريع مشتركة، وتحقيق التكامل الإقليمي.
ختامًا، تُعد أزمة سد النهضة تحدّيًا وجوديًا لمصر والسودان، وفرصة تنموية لإثيوبيا، ما يستدعي توافقًا دبلوماسيًا قائمًا على القانون الدولي ومبادئ العدالة المائية. وإذ يُعتبر السد، بصيغته الحالية، مشروعًا مخالفًا للقانون الدولي، نظراً لانتهاكه حقوق دول المصب التاريخية والطبيعية، فإنه يشكّل تهديدًا مباشرًا لحقها في الحياة، ولا يحقق توازنًا منصفًا بين الحقوق والواجبات. من هنا، فإن التوصّل إلى اتفاق عادل وملزم لا يخدم فقط أمن واستقرار المنطقة، بل يرسّخ نموذجًا مسؤولًا للتعاون بين الدول المتشاطئة، ويحوّل التوتر إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والشراكة الإقليمية.
د. ابراهيم العرب

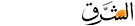
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.