بين مطرقة الشعبوية وسندان السياسة: قضية سلامة نموذجًا
بقلم د. ابراهيم العرب
من المؤسف أن يشهد لبنان، في خضم أزماته المتعددة، محاولات متزايدة لتحويل القضاء إلى أداة بيد السياسة، ومسرح لتصفية الحسابات، بدل أن يبقى سلطة مستقلة تستمد مشروعيتها من الدستور والقانون. فبعض الأطراف التي زعمت أنها ترفع شعار “استقلالية القضاء” و”مكافحة الفساد”، نجدها اليوم أول من يطعن في قراراته متى لم تأتِ على هواها أو لم تخدم أجنداتها الآنية. وهذه الازدواجية الخطيرة تهدّد ما تبقى من الثقة العامة بالمؤسسات، وتكرّس صورة عدالة انتقائية تكيل بمكيالين: «تُصفّق حين تدين الخصوم، وتستنكر حين تُطبق القواعد نفسها على من لا يروق لها».
إن قضية إخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، تُمثّل نموذجًا صارخًا على هذا التداخل بين القانون والسياسة. فالقرار لم يكن منّة أو مكرمة لأحد، بل استحقاق قانوني محض، تُحتّمه أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على حدود قصوى للتوقيف الاحتياطي:
«في الجنح: شهران قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حالة الضرورة القصوى.
في الجنايات: ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلّل، أي سنة واحدة كحد أقصى».
وبما أنّ سلامة تجاوز فترة 12 شهرًا موقوفًا، بل بلغ أكثر من 13 شهرًا قبل الإفراج عنه، فإن إطلاق سراحه لم يكن خيارًا سياسيًا ولا انتصارًا شخصيًا، بل كان التزامًا واجبًا بتطبيق القانون. وبالتالي، كان الاستمرار في توقيفه ليشكّل خرقًا سافرًا للنصوص المرعية، وهو ما لا يجيزه لا الدستور ولا القوانين النافذة.
والمثير للاهتمام أنّ الهيئة الاتهامية في بيروت ربطت قرار الإفراج بكفالة مالية غير مسبوقة، بلغت في بادئ الأمر 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، قبل أن تُخفّض إلى 14 مليون دولار نقدًا و5 مليارات ليرة، إضافة إلى منعه من السفر لمدة سنة. هذا القرار، على الرغم من طابعه الردعي، يثير نقاشًا فقهيًا مشروعًا، إذ يعتبر بعض الاجتهاد أنّ اشتراط الكفالة بعد انقضاء المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي يُعدّ غير ذي أساس قانوني، لأن المشرّع حدّد بوضوح أن الإفراج بعد هذه المدة يصبح واجبًا وغير مشروط.
أما سياسيًا، فإن المواقف المتقلّبة تجاه سلامة تكشف هشاشة المشهد اللبناني. فبعد انتهاء ولايته في حاكمية مصرف لبنان، سارع بعض الأقطاب السياسيين إلى الترويج لتمديد ولايته أو لإبقائه مستشارًا للحاكمية الجديدة، قبل أن ينقلبوا فجأة عليه بمجرد أن واجهوا اعتراضات دولية وغربية على هذه الطروحات. وهكذا تحوّل الرجل من “رجل دولة” إلى “كبش فداء”، في مشهد يُظهر، كيف تُخضع الطبقة السياسية العدالة لحسابات الربح والخسارة، بدل أن تتركها تسير وفق مقتضيات النصوص القانونية.
لكن الأهم من ذلك هو ما يكشفه هذا الملف عن علاقة السلطة السياسية بالقضاء. فالمطالبة بتسريع المحاكمات وتوزيع الاتهامات المسبقة على شاشات التلفزة ومنابر الإعلام، تُحوّل العدالة إلى حملة انتخابية مبكرة وإلى وسيلة لتصفية الحسابات، بدل أن تكون أداة لتحقيق الحق والإنصاف. ومن هنا يصبح واجبًا التنبيه إلى أن تحميل سلامة وحده وزر الانهيار المالي هو ظلم فادح، بل هروب من الحقيقة. فالانهيار لم يكن نتاج قرارات فردية، بل ثمرة منظومة كاملة متشابكة: “دولة راكمت الديون بلا إصلاحات، مصارف جازفت بودائع المودعين، حكومات ضغطت على المصرف المركزي لخدمة سياساتها، وطبقة سياسية عاشت على المحاصصة والتسويات”. كما أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واضحة في هذا الشأن: “المسؤوليات موزعة، ومن غير الجائز حصرها في شخص واحد مهما كان موقعه”.
إن الدفاع عن تطبيق المادة 108من قانون أصول المحاكمات الجزائية ليس دفاعًا عن رياض سلامة كشخص، بل عن مبدأ جوهري هو سيادة القانون. فإذا بات الالتزام بالنصوص جريمة في نظر بعض القوى، فإننا نكون أمام مسرحية هزلية تُقوّض ما تبقى من شرعية القضاء. في حين أن العدالة لا تُجزّأ ولا تُطبّق بانتقائية، وإلا تحولت إلى أداة للابتزاز والتشهير.
المطلوب اليوم أن يُحاكم سلامة أمام قضاء عادل ومستقل، لا أمام محاكم الإعلام والسياسة. وهو يبقى، شأنه شأن أي شخص، بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم مبرم. وهذه القاعدة البسيطة هي صمام الأمان لأي نظام قانوني، وهي ما يجب أن يدافع عنه القضاة وأهل القانون، بعيدًا عن ضجيج الحملات الشعبوية.
إن احترام القانون كما هو، لا كما تمليه المصالح، هو المدخل الأساسي لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، ولحماية القضاء من محاولات التسييس والتوظيف. فوحدها سيادة القانون، المطبّقة على الجميع من دون استثناء، قادرة على إعادة الاعتبار إلى دولة المؤسسات التي تآكلت بفعل الفساد والتجاذبات السياسية.
وفي المحصلة، إن قضية رياض سلامة تكشف، في جوهرها، إشكالية أعمق من مجرد توقيف فرد أو إخلاء سبيله؛ فهي تعكس مأزق النظام اللبناني في احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ركن أساسي في الدستور اللبناني المستوحى من النموذج البرلماني الفرنسي. فالمادة 20 من الدستور نصّت بوضوح على أن “السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، ضمن نظام ينص عليه القانون، ويضمن بمقتضاه استقلالها وحقوق المتقاضين”. غير أن الممارسة العملية أظهرت أن القضاء كثيرًا ما يتأثر بضغوط السلطتين السياسية والإعلامية، ما يحوّله من سلطة مستقلة إلى أداة ضمن لعبة التوازنات الداخلية. وهنا يبرز الخطر:” فإذا ما استسلم القضاء لضغوط الشارع أو إملاءات السياسيين، سقط مبدأ الاستقلالية، وأُفرغ الفصل بين السلطات من مضمونه، لتحلّ مكانه هيمنة السلطة السياسية على ما عداها”.
وعليه، شكّل احترام المادة 108 أ. م. ج في قضية سلامة، اختبار لمتانة دولة القانون في لبنان. فالالتزام الحرفي بالنصوص، رغم الضغوط، يعني أن القضاء لا يزال يتمسّك بدوره كسلطة قائمة بذاتها. أما الخضوع للابتزاز السياسي أو مسايرة الشعبوية، فهو انتقاص من استقلاليته، ويؤسس لسابقة خطيرة تهدد ما تبقى من الدستور. من هنا، فإن المخرج ليس في استغلال القضاء لتصفية الحسابات، بل في تحصينه عبر توفير الضمانات الدستورية والعملية لاستقلاليته، بحيث يكون قادرًا على متابعة محاكمة أي مسؤول، كبيرًا كان أم صغيرًا، في إطار من العدالة المتوازنة، بعيدًا عن منطق الكيدية أو الحصانات السياسية. ذلك وحده ما يعيد الثقة إلى القضاء ويكرّس فعليًا مبدأ الفصل بين السلطات، بما يضمن توازنًا حقيقيًا داخل النظام الدستوري اللبناني.
د. ابراهيم العرب

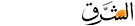
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.