ترامب – بوتين: صفقة القرن أم مقامرة القرن؟
بقلم موفق حرب
«أساس ميديا»
هل يمكن لقمّة ألاسكا أن تُكتب في التاريخ كلحظة انعطاف تُعيد تشكيل النظام الدولي، أم ليست سوى مقامرة جديدة من دونالد ترامب قد تنتهي بمزيد من الانقسام وعدم الاستقرار؟
بين طموحه في استمالة روسيا لتطويق الصين، وهواجس أوروبا من تكرار سيناريو “الاسترضاء”، وبين حسابات الشرق الأوسط وآسيا، يظلّ السؤال معلّقاً: هل ينجح ترامب في تحويل مغامرته الدبلوماسية إلى معادلة قوّة جديدة تخدم شعار “أميركا أوّلاً”، أم الرهان قد ينقلب عليه وعلى النظام العالميّ بأسره؟
في 15 آب 2025، تحوّلت قاعدة إلميندورف – ريتشاردسون في أنكوريج، ألاسكا، إلى مسرح لمشهد استثنائي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لم يكن اللقاء مناسبة بروتوكوليّة، بل محاولة مدروسة من ترامب لتقديم نفسه زعيماً قادراً على كسر الجمود الدولي عبر ما يسمّيه “الدبلوماسية الشخصيّة”. فقد أشاد علناً بتفاهمه مع بوتين، واعتبر أنّ “من الجيّد أن تتّفق قوّتان عُظميان، خاصّة إذا كانتا قوّتين نوويّتين”. والأهمّ أنه ذكّر ووضع روسيا في مرتبة “القوّة الثانية نوويّاً بعد الولايات المتّحدة”، في رسالة تحمل ما هو أبعد من المجاملة الدبلوماسية وتبعث برسالة إلى الصين، المنافس الوحيد للولايات المتّحدة على الزعامة الاقتصادية.
روسيا في المرتبة الثّانية؟
لكن خلف هذه الكلمات يكمن رهان محفوف بالمخاطر. فالقمّة لم تُنتج اتّفاقاً ينهي الحرب في أوكرانيا، ومع ذلك يسعى ترامب إلى تسويقها كخطوة على طريق صياغة معادلة جديدة: شراكة أميركية-روسية تُعيد رسم التوازنات وتخدم أجندة “أميركا أوّلاً”. صحيح أنّ روسيا المنهكة بالحرب والمعزولة دوليّاً قد تكتفي بمكسب رمزيّ هو الجلوس على قدم المساواة مع واشنطن، إلّا أنّ ترامب هو من يراهن على عوائد أكبر: الحدّ من صعود الصين، وتوسيع نفوذ الولايات المتّحدة، وجني فوائد تجاريّة واستثماريّة.
غير أنّ هذا الطموح قد تكون له ارتدادات عكسيّة. فالتقارب مع موسكو قد يثير قلق أوروبا الشرقية التي ترى في روسيا تهديداً وجوديّاً، ويضعف الثقة داخل الناتو. وقد تُفسَّر استمالة بوتين، الذي يواجه عزلة غير مسبوقة، كاسترضاء على حساب المبادئ التي طالما دافعت عنها واشنطن. ما بين الطموح والتهوّر، يبقى رهان ترامب مقامرة كبرى: إمّا أن ينجح في إعادة تموضع استراتيجي يعيد للولايات المتّحدة زمام المبادرة، أو أن يفتح الباب لشرخ جديد في التحالفات الغربية ينعكس سلباً على النظام الدولي.
تحمل تصريحات ترامب التي وضعت روسيا في المرتبة الثانية نوويّاً رسالةً مزدوجة: تعزيز مكانة موسكو وتقزيم دور بكين في معادلة القوى. هذه الخطوة، المتجذّرة في نهج ترامب “أميركا أوّلاً”، تفتح الباب لشراكة قد تسهم في استقرار بعض الملفّات الدولية وتحقّق مكاسب اقتصادية واضحة، فيما يجري الحديث عن فرص واعدة في القطب الشمالي، الفضاء ونقل التكنولوجيا.
أوروبا في حالة تأهّب
القارّة الأوروبية هي الأكثر تأثّراً بأيّ تقارب أميركي–روسي. تنظر دول شرق أوروبا والبلطيق بعين الريبة إلى أيّ صفقة قد تمنح موسكو شرعيّة أو نفوذاً إضافيّاً، وتخشى أن يتكرّر سيناريو “الاسترضاء” على حساب أمنها.
أمّا في برلين وباريس، فالموقف أكثر توازناً. المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يرحّبان بتخفيف حدّة الحرب وخفض تكاليفها الاقتصادية، لكنّهما يصرّان على أن لا يكون الثمن سيادة أوكرانيا. في المقابل، تبدو دول جنوب أوروبا أكثر براغماتية، إذ ترى في استقرار أسواق الطاقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية مكاسب مباشرة. ومع ذلك، يبقى الهاجس في بروكسل أنّ أيّ تفاهم ثنائيّ بين واشنطن وموسكو قد يتجاوز دور الناتو والاتّحاد الأوروبي.
في الشرق الأوسط، يمكن أن يُترجم النفوذ الروسي في المنطقة وعلاقات موسكو مع إيران إلى تعاون منسّق مع واشنطن، إذا نجح ترامب في تحويل التنافس إلى تقاطع مصالح. هذا قد يمنح الاستقرار الإقليمي دفعة، لكنّه يثير أيضاً قلق حلفاء مثل إسرائيل والسعوديّة.
أمّا في آسيا، فالمعادلة أكثر وضوحاً: ترامب يطمح إلى جذب موسكو بعيداً عن بكين. تعليق الرسوم الجمركية على مشتري النفط الروسي وتلميح بوتين إلى تعاون في مجالات التكنولوجيا والقطب الشمالي، كلاها مؤشّران إلى محاولة إعادة توجيه روسيا. نجاح هذه السياسة قد يرغم الصين على إعادة حساباتها في تايوان وبحر الصين الجنوبي. لكنّ فشلها سيمنح موسكو اعترافاً إضافيّاً بينما تظلّ معتمدة على بكين.
استدعاء التاريخ هنا لا يمكن تجاهله. مبادرة ترامب في ألاسكا تستحضر مقامرة نيكسون عام 1972 عندما انفتح على الصين لتطويق الاتّحاد السوفيتي. اليوم يحاول ترامب تكرار اللعبة لكن بالمقلوب: استمالة روسيا لتطويق الصين.
لكنّ الفارق كبير. فالصين في سبعينيّات القرن الماضي كانت دولة ضعيفة ومعزولة، وأمّا روسيا اليوم فهي محاصَرة بالعقوبات، غارقة في حرب أوكرانيا، وتعتمد على الصين اقتصاديّاً. أيّ تقارب مع موسكو سيكلّف واشنطن ثمناً باهظاً، وقد يتطلّب تنازلات في العقوبات أو حتّى قبول تعديلات حدودية في أوكرانيا.
أوكرانيا: ميدان الاختبار
على الرغم من عدم إعلان صفقة نهائية في ألاسكا، فقد أظهرت القمّة تقدّماً في ملفّ أوكرانيا. دعا ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض في 18 آب، فيما أبدى بوتين استعداداً للتسوية. إن تمكّن ترامب من تحقيق وقف لإطلاق النار، فسيمهّد لذلك باعتباره الخطوة الأولى نحو إعادة صياغة النظام العالمي. لكنّ أيّ تسوية تقوم على “الأرض مقابل السلام” قد تفتح جرحاً جديداً في الناتو وتضعف وحدة أوروبا.
بين الطموح والواقعية، يراهن ترامب على علاقة شخصيّة مع بوتين لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية. أنصاره يرون فيها مقامرة ذكيّة تستعيد إرث نيكسون وتفتح آفاقاً اقتصاديّة واستراتيجيّة هائلة. أمّا منتقدوه فيحذّرون من أنّها قد تقوّض التحالفات، وتمنح بوتين مكافأة سياسية على الرغم من ضعفه، وتُبقي روسيا في نهاية المطاف في مدار الصين.
لم تكن قمّة ألاسكا نقطة النهاية للنزاع الأوكراني، لكنّها ربّما كانت بداية لرهان أكبر: هل يمكن لشراكة أميركية–روسيّة أن تعيد رسم خارطة العالم، خصوصاً أنّ ترامب لا يزال في بداية ولايته الثانية… أم هي مقامرة جديدة قد تفتح صدعاً أعمق في النظام الدولي؟
موفق حرب

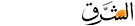
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.