سوريا بعد رفع العقوبات: نمرٌ اقتصاديّ صاعد
بقلم أحمد الراشاني
«أساس ميديا»
في اليوم الذي رفعت فيه الولايات المتّحدة “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظّمات الإرهابية حطّت طائرة الرئيس السوري أحمد الشرع في أبوظبي، فشكّل هذا التلازم بين الحدثين دلالة رمزيّة على القطع مع الماضي وتبنّي “فكرة وطنيّة” مختلفة في دمشق.
تُسجّل المركزيّة للقوّة الاقتصاديّة في الفكرة الوطنية صعوداً في السعوديّة، حيث تحوّلت “رؤية 2030” إلى مشروع شخصيّ يجمع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم المحلّية ومستوياتهم الوظيفيّة.
وفي الإمارات بشكل خاصّ تجسّد مركزيّة النجاح الاقتصادي الباهر في الفكرة الوطنية، حتّى إنّك تجد كلّ مواطن معتدّاً بهذا النجاح وشريكاً فيه ومنتمياً إليه وحريصاً عليه بشكلٍ شخصيّ. ويمتدّ هذا الانتماء والاعتداد إلى المقيمين في البلاد، فتجدهم يتحدّثون عن هذا النجاح كمصدر فخرٍ لهم، وتجدهم معنيّين بالمشاركة فيه والحرص عليه.
الهويّة قبل التّنمية
لم يكن لهذا الباب من الفكرة الوطنية حظٌّ في الدولة القومية العربية عند نشأتها بعد الحرب العالميّة الأولى امتداداً حتّى سبعينيّات القرن الماضي. إذ كان سؤال الهويّة والتحرّر متقدّماً على سؤال التنمية والنجاح الاقتصادي، بل إنّ الاقتصاد لم يكن أكثر من تفريع من الاختيار بين المعسكرين الغربي والاشتراكي.
المفارقة أنّ لبنان جرّب، إلى حدّ ما، وضع الاقتصاد في مركز الفكرة الوطنية مرّتين: مرّةً في الخمسينيّات والستّينيّات، حين وفّر النموّ الاقتصادي السريع عنصراً لفكرة وطنيّة غرقت لاحقاً في أمواج الانقسامات المحلّية والخارجية، ومرّةً مع رفيق الحريري، الذي كان يظنّ أنّ بإمكان مشروع النهوض أن يوفّر قوّة دفع تجرف مشاريع التقسيم والانقسام.
تمثّل انعطافة أحمد الشرع الحادّة بعد دخوله دمشق محاولة جدّية للتحوّل من سؤال الهويّة إلى سؤال الاقتصاد. وإذا كان هذا الأخير يبدو أسهل ظاهريّاً، لأنّه يقفز فوق الاختلافات الفكرية والعقائدية، إلّا أنّه مرتبط بكلّ تعقيدات السياسة والمحاور. فالمنطقة اليوم منقسمة بين محور يضع الاقتصاد في المقدّمة، ومحور يضع في رأس اهتماماته الهيمنة على العواصم عبر الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدول. وفي الصورة الكبرى، يتحكّم الاقتصاد في تشكيل المحاور والتكتّلات والعلاقات الدوليّة.
لكلّ ذلك، ليس رفع العقوبات خطوة تقنيّة في الحالة السوريّة، بل هو صلب مشروع الدولة الجديدة. فإعادة الإعمار وبناء الاقتصاد يتطلّبان ما يراوح بين 250 و400 مليار دولار. وهذه الأموال لن تأتي من خزائن الدولة السورية، بل من الاستثمارات التي كان رقمها السرّي في جعبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد اختار أن يقدّمه هديّة لوليّ العهد السعودي محمّد بن سلمان. ولذلك يُطرح السؤال عن خيارات الدولة السوريّة تجاه محيطها، وتجاه استثمارها لمواردها الطبيعية، وتجاه ما تمنحه من امتيازات للاستثمارات العربية والأجنبية.
تحويلات بين 7 و10 مليارات دولار
بدأ الأثر المباشر يظهر من خلال تحرير التحويلات وتدفّقات رأس المال، لا سيما من المغتربين السوريّين، التي يمكن أن تضخّ ما بين سبعة إلى عشرة مليارات دولار سنويّاً في الظروف الطبيعية. وهذا كفيل بتسهيل مهمّة البنك المركزي السوري بعد سنوات من شحّ الاحتياطات والتضخّم المفرط.
أهمّ ما يحرّره رفع العقوبات هو استثمار الثروات الطبيعية السورية، ما هو مستكشف منها وما هو محتمل. وأهمّ ما فيها الاحتياطات النفطية التي تُقدّر بـ2.5 مليار برميل من النفط، وهو رقم ضئيل بالمقاييس العالمية، لكن ربّما يكون بإمكان سوريا العودة بمستويات الإنتاج إلى ما بين 300 و500 ألف برميل يومياً خلال سنوات قليلة، وهو ما قد يكون كافياً لتغطية الاستهلاك المحلّي.
أمّا الغاز فالأهمّ فيه امتيازات الاستكشاف في المنطقة الاقتصادية البحريّة قبالة السواحل. وحتّى الآن، ما يزال الحديث عن وجود احتياطات بكميّات تجاريّة ضرباً من التكهّن، خصوصاً مع عدم وجود اكتشافات في أيٍّ من المناطق القريبة، سواء في الجانب التركي أو القبرصي أو اللبناني.
لدى سوريا احتياطات لا بأس بها من الفوسفات تقارب مليارَي طنّ، أي ما قد يصل إلى ضعف الاحتياطات الأردنية. وعلى الرغم من تزايد الاعتماد على الفوسفات عالميّاً في صناعات الطاقة النظيفة، إلى جانب الاستخدامات التقليدية في القطاع الزراعي، إلّا أنّه ليس كفيلاً بإحداث تغيير في المشهد الاقتصادي، وإن كان يوفّر رافداً ماليّاً لا بأس به. فالأردن مثلاً لم تتجاوز صادراته من الفوسفات العام الماضي 1.7 مليار دولار. وفي كلّ الأحوال، يبقى الأمر مرهوناً بإدارة العلاقة مع روسيا التي تسيطر على امتيازات إنتاج الفوسفات السوريّ.
نافذة العمق العربيّ إلى المتوسّط
ربّما تكمن الإمكانات السوريّة الكبرى في موقعها الذي يمكن أن يوفّر نافذة للعمق العربي إلى البحر المتوسّط، ليس فقط من خلال الموانئ وخطوط التجارة، بل عبر شبكات الاتّصالات والألياف الضوئية، وخطوط أنابيب الغاز والربط الكهربائي. وهذا الربط هو الأكثر استراتيجيّة لأنّه موضوع التنافس الأهمّ مع إسرائيل. ويكفي أنّ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أتى بنفسه من واشنطن إلى الهند ليطلق مبادرة الممرّ الهندي إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط (IMEC)، وفي لبّها إدماج إسرائيل في هذه الشبكة.
هنا سيكون على الإدارة السوريّة أن تدير المنافسة والخيارات بعناية. وقد كانت باكورة تلك الخيارات منح ميناء اللاذقية لشركة CMA-CGM الفرنسية التي تساهم فيها مجموعة تركيّة بنسبة 25% في المئة، وميناء طرطوس لـ”موانئ دبي” الإماراتية، وأكبر عقود الطاقة بسبعة مليارات دولار لكونسورتيوم قطري – أميركي. لكنّ الأمر لا ينتهي عند هذا الحدّ، فنجاح هذه العقود يتطلّب عملاً كثيراً على النموذج الاقتصادي الذي تقع هذه العقود في صلبه.نمر اقتصاديّ صاعد
يمكن لسوريا، على الورق، أن تتحوّل إلى نمر اقتصادي صاعد بانحيازها إلى محور النمو العربي، وبإمكان سوريا أن تتحوّل إلى مركز للطاقة واللوجستيّات والسياحة، لا سيما في حال اندماجها في شبكة المشاريع الكبرى الممتدّة من الخليج إلى البحر المتوسّط. لكنّ ذلك يتطلّب إدارة توازن دقيق مع محيطها المعقّد، من تركيا إلى إسرائيل والعراق ولبنان.
يبقى أنّ محاولة سوريا إعادة تشكيل الفكرة الوطنية على أساس الاقتصاد والنموّ تبدو جدّيّة ومقنعةً للخارج، في الوقت الذي يظهر فيه لبنان عالق في مكان ما بين جنوب الليطاني وشماله؟
أحمد الراشاني

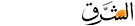
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.