في حضرة السّؤال المؤجّل: ما هي سوريا وكيف تكون؟
بقلم نديم قطيش
«أساس ميديا»
حين تهاوت آخر بقايا نظام آل الأسد في سوريا في كانون الأوّل 2024، فُتحت البلاد على سؤال مؤجّل منذ قرن: ما هي سوريا؟ ومن يملك تعريفها؟ فما أعقب سقوط النظام لم يكن صراعاً على السلطة فحسب، أو إعادة تكوين لها، بل لحظة مواجهة مكشوفة بين مكوّنات المجتمع السوري، بشأن معنى الهويّة الوطنية وشكل الدولة الناشئة.
لم تكن أحداث الساحل السوري ساحة لمجزرة انتقاميّة تعرّضت لها البيئة العلويّة الحاضنة للنظام البائد فقط، بل انفجار اجتماعي وسياسي لسؤال الطائفة والدولة والعدالة الانتقالية. ومثلها معركة السويداء التي حملت إعلاناً صريحاً من طائفة بأكملها بأنّها غير مستعدّة للقبول بالتمثيل الرمزي في جمهورية تُعاد صياغتها خلف أبواب مغلقة. وربّما يكون التجاذب الحاصل بين الكرد والحكومة المركزيّة في دمشق، هو الاختصار الأوضح لهذه العلاقة المرتبكة، في ضوء رغبات الإدارة الذاتيّة الكرديّة وتصوّرات الحكم المركزي الكلاسيكي الذي يتبنّاه الرئيس السوري أحمد الشرع.
ما يخيف الدروز والكرد والمسيحيّين والعلويّين وغيرهم، هو الاستعجال الذي يحاول بالشعارات أن يحسم نقاشات مفتوحة وعميقة ومعقّدة تتّصل بالنظام السياسي وهويّة الدولة وتوازنات المجتمع.
وطن جامع أم سلطة مركزيّة؟
في الحالات جميعاً، تتجاوز التجاذبات مسألة التفاوض على صلاحيّات أو مكتسبات، وتأخذ، على نحو أكثر علنيّة، شكل التفاوض على تعريف سوريا نفسها: هل هي وطن جامع أم سلطة مركزيّة تحتل تمثيل الشعب السوري؟
هل سقط نظام الأسد وبقيت دولة الأسد بعتادها اللغويّ وترسانة الأوهام نفسها عن الوحدة والوطن والمجتمع؟!
كلّ مكوّن، من الساحل إلى الجزيرة، ومن جبل العرب إلى الغوطة، يعبّر عن برمٍ ما بثقافة الوحدة القسريّة مطالباً بحقّه في كتابة عقد اجتماعي جديد، أو على الأقلّ بحقّ الاعتراض على استمرارية العقد الاجتماعي المُرساة دعائمه في ظلّ الدكتاتوريّة الأسديّة.
في خلفيّة هذا المشهد، تحاول السلطة الانتقالية ترميم البناء السوري بمفردات مستعارة من أدبيّات الدولة المركزية القديمة: “استعادة السيادة”، “بسط الأمن”، “هيكلة الجيش” و”رفض التقسيم” وغيرها من العناوين التي يُراد لها أن تغشي الأبصارَ السؤالَ الأكبر: من الذي يمنح هذه الدولة شرعيّتها اليوم؟ وهل يمكن لها أن تتجاوز جدلية العلاقة بين خوف الأقليّة وقدرات الغلبة لدى الأكثريّة، وأن تُقصي الجهد الضروري المطلوب للإجابة عن سؤال المواطنة والتمثيل والهويّة؟
لا يملك السوريون ترف أن تكون لحظتهم الراهنة لحظةَ انتقال سياسي وحسب، بل هي لحظة مراجعة جذريّة لنموذج الدولة ذاته، وتعريف الهويّة الوطنية من أصلها، وهذا من الأثقال التي لا تُناط بمسلّحين وميليشيات ولا خطابات منمّقة ولغو مستعمل.
لم تعد المسألة إسقاط نظام فقط، بل تجاوز ثقافة سياسية بكاملها، نحو إعادة صياغة العلاقة بين المركز الدمشقيّ والمراكز الأخرى، ولا أقول الأطراف، وبين الجماعة السورية الوطنية وبين الفرد السوري الحافلة سوريّته بهويّات فرعيّة خاصّة وشديدة الحضور، وإلّا فإنّ سوريا الجديدة لن تكون إلّا إعادة إنتاج مشوّهة لسوريا القديمة، بأسماء جديدة وأوهام متجدّدة.
هل كانت سوريا دولةً موحّدة فعلاً؟ أم كانت وحدتها، كما يخشى كثيرون اليوم، هندسةً سلطويّة شمولية لقمع الانقسام لا لتجاوزه؟ وهل الحكم المركزي هو الشكل الوحيد للوحدة المرغوب فيها؟
هذا السؤال، المعلّق منذ عقود، وجد نفسه وجهاً لوجه أمام واقع سياسي واجتماعي عارٍ من أدوات التجميل القوميّ أو الحكم من خلال الجريمة المنظّمة.
وحدة أم إذعان؟
ثمّة مبالغات كبرى في الحديث عن سوريا المعاصرة، تُصوّرها كما لو أنّها دولة مركزية عريقة متجذّرة في التاريخ السياسي للمنطقة، وتملك تقاليد ومؤسّسات حكم راسخة وهويّة وطنيّة مستقرّة.
لكنّ الحقيقة التي يُصار إلى طمسها غالباً في السرديّات القومية أو النوستالجيات المتخيّلة أنّ سوريا لم تُتَح لها فرصة فعليّة لبناء دولة حديثة بعد نهاية الانتداب الفرنسي.
صحيح أنّ بدايات الدولة السورية في الأربعينيات والخمسينيات كانت واعدة من حيث الحراك السياسي والفكري، لكنّها كانت مفخّخة أيضاً بأعباء بنيويّة كصراعات النخب ولو بهدوء صاخب وتنافس القوى الخارجية واختراقاتها وفقدان التوازن بين العسكرة والمدنيّة.
مع انقلاب البعث عام 1963، ثمّ انقلاب حافظ الأسد على الانقلاب عام 1970، دخلت سوريا طوراً جديداً: لم تعُد دولةً تسعى إلى بناء مؤسّسات، بل تحوّلت إلى بنية فوق–دولتيّة، تدمج الحزب بالأمن، وتُفرغ الفضاء العامّ من كلّ حياة سياسيّة حقيقيّة. الحقبة الأسديّة بالتحديد لم تكن استمراراً هشّاً لبناء مأزوم، بل كانت نفياً جذريّاً لفكرة الدولة–الوطن، وابتلاعاً منظّماً للمجتمع والهويّة معاً عبر هندسة الخوف والطائفية والولاء الشخصي.
لم تحظَ سوريا بعد بلحظة بناء حقيقي لذاتها، وما يُقدَّم في الخطاب العامّ بهذا الخصوص لا يعدو كونه أوهاماً وخيالات وحدويّة أو قوميّة لا تقوم إلّا بتجاهل هذه الحقيقة البنيوية المؤلمة.
والحال، لا يعود انكشاف التصدّعات اليوم في البنية السوريّة فقط إلى صراعات أنانيّة على السلطة أو مؤامرات خارجية تتوسّل هويّات داخلية، بل هي وليدة هذا الغياب التاريخي العميق لفكرة الدولة ذاتها: دولة العقد الاجتماعي والتوازن بين المكوّنات، ودولة الشرعية المتأتّية عن بناء الإجماعات والمشاركة عبر القوّة أو لحظات نصر متخيّلة يجري فصلها وعزلها عن ديناميّات الثورة السورية المعقّدة والبادئة عام 2011، في أقلّ تقدير.
التعدّدية السوريّة ليست “عطلاً” ينبغي تجاوزه بتعويذات الحكم المركزي، بل واقع بنيوي متجذّر لا توجد وصفات وحدويّة جاهزة للتعامل معه.
الوحدة التي لا تحمي حرّية مكوّناتها ليست وحدة، بل عقد إذعان. وسوريا، بعد كلّ هذا الدم، تستحقّ ما هو أكثر من ذلك.
نديم قطيش

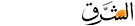
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.